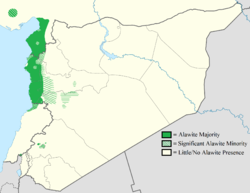مدخل (1)
أتت بعض الأفكار اليونانية القديمة بعبارة ” إن اسم “الله” هو اسم خالٍ من أي معنى”.
هذه هي الفرضية التي يتم الانطلاق منها، وبالاستناد إلى العديد من المراجع من أجل تفكيك هذه المقولة وفهمها. العمل شاق وطويل وهذه الخطوة الأولى، أتقاسمها مع المهتمين.
بعد سنوات طويلة من ظهور الفلسفة والفلاسفة، وجد المصريون القدماء أنفسهم مجبرين على النقش على أحد معابد الطبيعة هذا النقش الشهير:
” أنا كل ما هو كائن، كل ما كان، وكل ما سيكون، ولم يستطع أي كائن حي أن يثقب الحجاب الذي يغطيني”. كم احتاج الإنسان من سنين حتى وصل إلى هذه المقولة؟
رأى Ocellus de Lucanie (وهو من تلامذة أبيقور في القرن الخامس قبل الميلاد) أن الطبيعة ضمت في داخلها مبدأ وجودها، وأنها سبب وجود الكائنات الأخرى التي تعيش فيها، ومن هنا يستنتج أن الكون غير مُنْتَجٍ وغير قابل للتدمير وهذه إحدى أهم الخصائص الجوهرية للسبب الأول أو العلة الأولى.
لم يملك أحد شيئا قويا يعارض هذه الأطروحة، وهنا لا يمكن التعويل على خيال الشعراء ولا على الأفلاطونيين، ولا حتى على أفكار أقل مصداقية من ذلك بكثير كالأفكار التي تتحدث عن الوحي. أعطى أحد أكبر علماء الطبيعة في العصر القديم (الإيطالي Gaius Plinius Secundus)، للعالم كل الخصائص التي تتعلق “بالعلة الأولى” للتفكير الإلهي، يقول:
” العالم وما نسميه السماء واللذان يضمان كل الكائنات يجب أن ننظر إليهما وكأنهما الله، الأبدي، العظيم، الذي لا يُنْتَج والذي لا يموت”.
بالتالي، إن البحث عن كائن خارج عن الطبيعة أو خارجها هو أمر لا فائد منه بالنسبة للإنسان، وهو أمر أكبر من طاقته، فالطبيعة هي الخالدة وهي التي تضم كل شيء في داخلها، ومن الجنون البحث عن وجود خارج الطبيعة.
إن هذه الرؤية الدقيقة التي وضعها Gaius Plinius تشكل إحدى المبادئ الفلسفية الكبرى التي جاءت في أعماله حول “تاريخ الطبيعة”. يوجد عظمة للطبيعة على كل ما يُولَد، يعتقد أو يعيش فيها، عظمة لا تخطئها العين ولا يمكن رفضها. لقد تخيل الإنسان منذ وجوده سببا لا تمكن رؤيته وطبيعة مختلفة عن الطبيعة التي نراها، طبيعة متخيلة أسمى مما نشاهد وتهيمن على الطبيعة التي نعيش فيها، أما المؤمنون فقد صدقوا هذا الخيال وقبلوا به من غير قلق ومن غير البحث عن أية أدلة.
استمر الإنسان في وضع الطبيعة المتخيلة فوق الطبيعة التي يعيش فيها. لم يعارض أحد هذا الخيال، لكن هناك من شكك به. لو استطعنا التخلص من أوهام الحواس علينا في هذه الحالة أن نكون أكثر حذرا في الخيال، هذا الخيال الذي أصبح الميتافيزيقا أو ما نطلق عليه “ما وراء الطبيعة”. إذاً، “ما وراء الطبيعة” هو طبيعة متخيلة عند الإنسان ومن هنا بدأ أصل الاعتقاد والإيمان.
ما من أحد رأى الكون الذي نعيش فيه كيف نشأ، كيف وُلِد، كيف تطور، إنه دائما كما هو لا يتغير، إنه متكيف مع ذاته ويشبه ذاته. لذلك كان من الطبيعي والمنطقي أن يتوقف الإنسان عن البحث عن أشياء أعتقد أنها منتهية. كان على الإنسان أن يصعد إلى أعلى الشجرة ليبحث عن أسباب إنتاجها للثمار، وكان عليه أن يحفر في التراب ليجد جذور الشجرة، رأى أن الجذور والثمار، كلاهما، مُنْتَجَان ويُنْتِجان، لكن عملية الإنتاج وإعادة الإنتاج تنتهي دائما في التراب.
أصل المعتقدات
2
بناءً على ما أُشِيرَ إليه في المدخل (1)، كانت الطبيعة مجال بحث الإنسان الأول حول الألوهية أو حول العلة الأولى للوجود، ظل الأمر مستمرا حتى بدأ وضع عالم الأفكار خارج حدود الطبيعة، هذه الأفكار التي أسس لها الباحثون فيما وراء الطبيعة أو “الماوراء طبيعيون”. لكن هذه المحاولات من قبل الباحثين لم تكن سوى استثناءً بسيطا للآراء العامة حول الطبيعة، هذه الطبيعة التي ستبقى في حيازة لألوهيتها والتي ستجذب إليها كل الكائنات التي تموت والتي ستفرض قوانينها على المؤمنين.
إن عالمية المعتقد (الإيمان) يعود إذاً للطبيعة، وكي نتأكد من ذلك يمكننا الاستناد إلى جميع الآثار الأكثر قدما في التاريخ ولجميع الشعوب في العالم دون استثناء. نقرأ في “الاسفار اليهودية/أسفار موسى” العظات والتشريعات لفقهاء اليهود التي تحذر اليهود/والإنسان من أية عبادة للطبيعة. هؤلاء الفقهاء اليهود، والذين تربوا في مدارس روحانية، أرادوا نشر وفرض المذهب الماوراء طبيعي/الميتافزيقي وجعله القاعدة لدين شعب عاش في ذلك العصر، محذرا هذا الشعب مما هو غير مرئي وهيبة وعظمة مشاعل اللهب التي يمكن تخيلها فيما وراء الطبيعة، والهدف هو الاستثمار في شكل من اشكال الألوهية والتحدث باسم هذه الألوهية.
“تذكروا، يقول فقهاء اليهود، أنكم لم تروا أي شكلٍ، ولا أي شبيهٍ، لليوم الذي سيحدثكم في الله في “جبل حريب” (المكان الذي استلم فيه موسى وصاياه العشر من قبل الله، وهو المكان الذي يلتقي فيه إيليا مع الله)، الخوف الذي سيتملككم. لا تقع في الوهم والخطأ عندما ترفع عينيك إلى السماء وعندما ترى الشمس والقمر والنجوم، لا تعبد مخلوقات جعلها الله لخدمة العالم السفلي الذي هو تحت السماء”. كما نلاحظ هنا بداية حرب حقيقية لكل ما هو طبيعي من قبل فقهاء اليهود.
لم تكن هذه الأسفار سوى مجموعة من الحكايا والقصص، تشبه إلى حد بعيد قصص العرب وحكاياهم، ولكننا نرى بوضوح أن مخترعها هو شخص يعمل “بالروحانيات” ويدعو شعبه إلى الإيمان بالسبب أو العلة غير المرئية. كان الهدف الأول هو زعزعت الإيمان بالطبيعة وبالكون وضد كل الشعوب والحضارات القديمة في الشرق التي لم يكن لديها أي إيمان على الإطلاق بأي معتقد آخر سوى الطبيعة. وإذا لم نضع رؤية فقهاء اليهود ضمن هذا السياق فإننا لا نصل لأية نتيجة على الإطلاق في أسباب خلق “الماوراء طبيعي/الميتافزيقي” من قبلهم.
لقد عمل اليهود على خلق الصور والمعاني لمواجهة الطبيعة، وكلما كان تأثيرها قوي على الإنسان كلما كان للتجريدات الغيبية/الميتافيزيقية القدرة على تحطيم وتدمير كل معاني الطبيعة. لقد عمد فقهاء اليهود ومن وقف خلفهم على تدمير الاعتقاد بالطبيعة، هذا الاعتقاد المنطقي والطبيعي جدا عند الإنسان، رفعوا الصوت عاليا وباستمرار ضد الطبيعة.
جاء كل ذلك تحت ادعاء:” أن كل البشر، الذين لا يملكون معرفة الله، ليسوا سوى أشخاص أصابهم الغرور ولم يتمكنوا من الفهم. لم يعترفوا بأن ما يشاهدوه هو خلق الله. لقد تخيلوا أن النار، الرياح، والهواء الأكثر خفة والشمس والقمر، هي آلهة تحكم العالم لأنهم رأوا فيها الجمال ومتعة هذا الجمال والإعجاب بالطبيعة، لكنهم معجبون فقط بما خلق الله وهم لا يدرون، ولا يعرفون كم هو قوي ذاك الإله الذي خلق كل هذا وكم هو جميل”.
رأى مخترعو المعتقدات الغيبية أنه يمكن عذر أولئك الذين تمسكوا بقوة الطبيعة المرئية وأنهم لم يكونوا بحاجة إلى تخيل قوة أخرى خارج الطبيعة أو ما وراءها. كما رأوا أن هؤلاء البشر يمكن عذرهم أكثر من غيرهم لأنهم وقعوا في الخطأ أثناء البحث عن الله، لقد غرّهم جمال الطبيعة.
لقد كان على مخترعي المعتقدات الغيبية إيجاد صيغة أو نصوص أو منطق يؤكد أن هذا الجمال في الطبيعة يعود إلى جمال مخفي غير مرئي وليس سوى انعكاس له وليس أسمى منه.
أصل المعتقدات
(3)
لقد كان للمصريين والفينيقيين التأثير الأكبر على الآراء الدينية عند بقية شعوب العالم، لم يعرف المصريون والفينيقيون آلهة أخرى سوى الشمس، القمر، النجوم والسماء التي تضمهم، لم يغنّوا في أناشيدهم الدينية و “الوطنية” سوى للطبيعة. أول من ألحق الألوهية بالشمس والقمر والنجوم، ورأوا فيها كأسباب أولى لكل الكائنات وهي التي تؤدي إلى إنتاجها أو دمارها. لم يكونوا قد بدأوا بالحديث عما هو غير مرئي أو خفي ويقع وراء الطبيعة، باستثناء عدد قليل من الأشخاص معروفين عند اليهود الذين تحدثوا عما هو وراء المرئي أو وراء الظاهر (أي الباطن أو الخفي).
بدأ هؤلاء الأشخاص بالحديث عن إعجابهم “بخالق” و “مهندس” العالم، اقتنعوا بوجود إله واحد وهو وراء وحدة العالم، هذه المفهوم “وحدة العالم” الذي سيصبح القاعدة والأساس للأديان واللاهوت، نقلوا ذلك لأطفالهم وتعلم الأطفال أن هذه هي الحقيقة الوحيدة، الأولى والمذهب الوحيد الذي يعتقد بامتلاك حقيقة الألوهية. إن بقية الأشخاص، المعجبون بالسماوات وجمالها وينظرون إليها كآلهة، لم يرفعوا عباداتهم فوق السماء المرئية.
وصلت معتقدات الفينيقيين والمصريين إلى اليونان مع أساطير “أورفيوس” (أورفيوس في الميثولوجيا الإغريقية هو ابن الملك “أواغر”، اعتبرته الأسطورة أنه نبي وأصبح ملهما للحركة الدينية التي تسمى الأورفيزم”) ومع معرفة الحروف. لقد كان اليهود الوحيدين الذين نظروا إلى التراب، الماء، الهواء والنار، الشمس، القمر والنجوم وكل مركبات الكون، ليس كآلهة بل كأعمال إلهية، تخيلوا جوهرا ذكيا يسمو على كل هذه العناصر ويقود حركتها.
كان اليهود/العبرانيون مجبرين على الاعتقاد بأن هذا الدين (الغيبي/الماورائي) ليس معتقدهم الأول وأن “إبراهيم/إبراهام” (الشخصية التي لم توجد نهائيا وليست سوى محض خيال) وُلِدَ وكبر في “الصابئية” (التيار الديني اليهودي ـ المسيحي وقد ورد ذكرهم في النصوص الدينية في الأديان التوحيدية)، وفي دين من الذين يعبدون النار والطبيعة بكاملها.
إن الكلدانيين، الكنعانيين، السوريين، الذين يعيشون في وسط هؤلاء، والذين عمل اليهود إلى فصلهم عن معتقدات اليهود، لم يكن لديهم نفس الآلهة العبرانية. كرّس الكنعانيون أحصنتهم وعرباتهم مثلا للشمس وهي آلهتهم الكبرى.
كان سكان “إيميسا” (حمص) الفينيقية معجبون بإله تحت اسم Héliogabale وهو الإمبراطور الروماني Varius Avitus Bassianus، وهو أيضا حفيد الكاهن “يوليوس باسيانوس”، كاهن إله الشمس في مدينة حمص، وابن “جوليا سوإيمياس” الإمبراطورة الرومانية ـ الحمصية ابنة “جوليا مايسا” وابنة اخت “جوليا دومنا” (السورية ـ الحمصية والزوجة الثانية للإمبراطور سيبتيموس سيفيروس (الذي ولد في مدينة لبدة الليبية من عائلة أمازيغية). بنى سكان حمص معبدا جميلا له مرصعا بالذهب والفضة والأحجار الثمينة.
لم يكن فقط سكان حمص هم المعجبون به، بل حتى سكان الأقاليم والبلدان المجاورة حيث كانوا يحملون إليه كل عام الهدايا الثمينة. أما “هيراكل” الروماني، وهو المقابل لاسم “هيراكليس” في التاريخ الإغريقي، فقد كان الإله الأكبر عند سكان مدينة صور وهو نفسه إله الشمس بالنسبة لهم.
أُعجِب السوريون بالنجوم وبالمجموعة الفلكية “الأسماك” ورسموا لها الصور في معابدهم. كان معبد أدونيس في بيبلوس (جبيل في لبنان) رمزا لعبادة الشمس. وكان للشمس معبد رائع في تدمر السورية، المعبد الذي سرقه جنود أورليان الروماني، والذي أمر ببناء معبد آخر.
أما “بلييداس” (النجوم التي تقع في المجموعة الفلكية “الثور”) وكان اسمها Succoth-benoth هي آلهة بابلية وصلت عبادتها إلى ضفاف المتوسط. كان “زحل/ Saturne ” أو الكوكب الذي عرف بهذا الاسم، معبودا أيضا وهو الذي أقصى في النهاية الإله “شمس” (إله الخصب عند السوريين أو بعل/حدد) ليكرس العبادات اليهودية ويبعد العبادات السورية. نجد أيضا الكوكب “لوبيتير” أو جوبتير، يتغير اللفظ حسب اللغة، مارس، فينوس (عشتاروت)، كل هذه الأسماء هي آلهة سورية (فينيقية، سريانية، كنعانية).
“سانشون ـ ياتون”، (كاتب فينيقي يعود أصله إلى بيروت، والبعض يقول صور، لم يتم التعرف على أعماله إلاّ من خلال بعض المقاطع التي ترجمها “فيلون الجبيلي” في عهد الإمبراطور الروماني “هادريان” كما أشار إليه الأسقف ” يوسابيوس” أسقف فلسطيني أو عاش في فلسطين)، يقول:” إن الأشخاص الأوائل الذين سكنوا فينيقيا كانوا يرفعون الأيدي إلى السماء باتجاه الشمس وكانوا ينظرون إليها كسيّد وحيد للسماوات وكانوا يطلقون عليها “بعل شامين” (إله السماوات الفينيقي)”. كان إله جميع الشعوب التي تقطن شرق المتوسط وكان معبودا حتى في مصر وروما، إله الأرض والمطر والندى الذي حارب ضد الجفاف والموت والظلم، ووفق نتائج معركته ستأتي دورة من الخصوبة والوفرة أو دورة من الجفاف والمجاعة ستستمر سبع سنوات.
المصدر : الصفحة الشخصية
Salah Nayouf