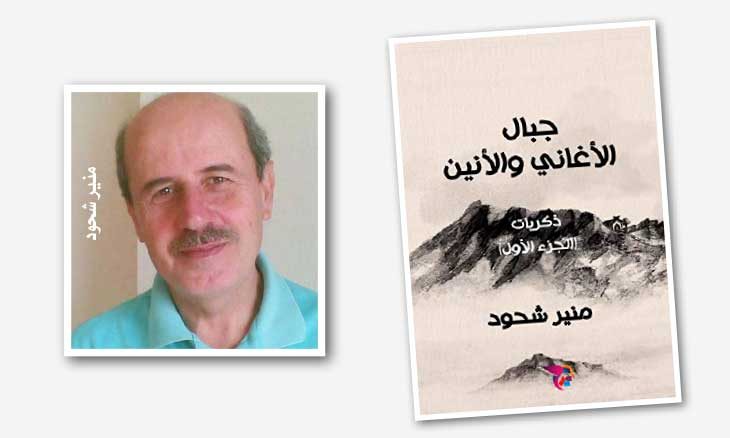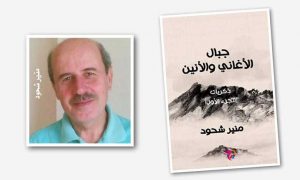
“كنت قد آويت إلى فراشي حين أيقظتني طرقاتٌ هادئة على الباب. مَن يا تُرى سيحلُّ ضيفًا عليَّ في مثل هذا الوقت؟ نهضت من سريري بلمح البصر، احترت بين أن أستفسر عن هوية الطَّارق أو أن أفتح الباب، وسبقتني يدي إلى مقبضه.
لمحت امرأةً أربعينية وقورة في غبش المساء، كانت ترتدي كنزةً سميكة مشغولةً يدويًا وتنورةً واسعةً تلامس كاحليها، كأنها ترتدي الأمومة أو أنّ الأمومة ترتديها، وغمرني شعور دافئ وجميل. للوهلة الأولى، لم أنتبه إلى تلك الفتاة الأنيقة التي كانت تقف وراء أمها وتبتسم بلا سبب. رجتني المرأة أن أساعد ابنتها في مادة الرياضيات، ووعدتني بمكافأة مجزية إنْ استطعت حمل الابنة على تجاوز عقدتها النفسية التي تقضُّ مضاجع الأسرة – مادة الجبر!
حاولت تقمُّص دور المدرِّس منذ البداية، لكنَّ غنج الصبيّة خضراء العينين أربكني، وهي لا منذ وقتٍ قريب، فضلًا عن رائحة عطرها النفَّاذة، التي جعلتني أكتشف بأنَّ ثمة روائحَ أخرى، غير تلك التي خبرتها، روائحُ يمكن أن تجتذبني للدوران كفراشةٍ حول عنق امرأة!
استغلّت الفتاة وجودي في بيتهم إلى أقصى حدّ، تباهت أمامي بحركاتٍ استعراضية زادتها أناقةً وجمالًا، ولم أملك سوى خجلي، وكنزتي الصوفية المدعّمة عند المرفقين بقطعتين من الجلد، والتي كانت من نصيبي في آخر دفعة من ثياب “البالة” المرسلة من بيت خالي في طرابلس.
ومن حين لآخر، كانت الأم تقاطع استغراقنا ما بين “سين” المعادلة و”عينها”، تستفسر عن سير الدروس وتقدُّم الفهم والاستيعاب، وهي تحمل صينيةً عامرةً بأنواع الحلوى والبرازق، مع الشاي الذي تألّقت حمرته في كأسين من فخر صناعة الزجاج الفرنسية. حينئذٍ، تسارع “طالبتي” لعضّ قلم الرصاص، أو قضم الممحاة الصغيرة في مؤخِّرته، وهي تُمعن التحديق في الرموز الجبرية، التي مضى على كتابتها أسبوع واحد على الأقل”!
مقطع من : جبال الأغاني والأنين .
ذكريات ( الجزء الأول ) الدكتور : مُنير شحّود .